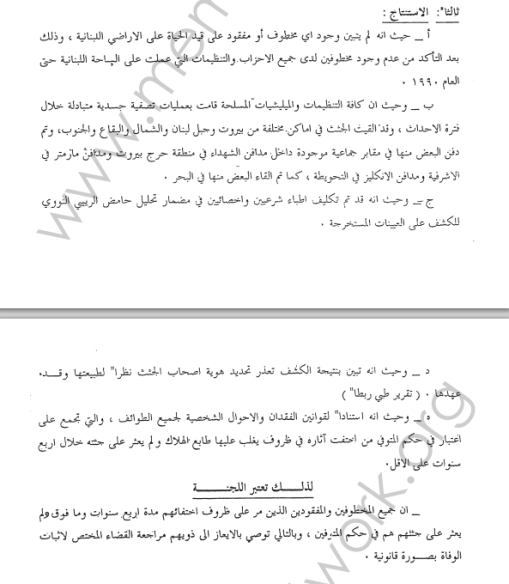“بصيت لروحي فجأة. تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي” – عبد الباسط حمودة
غاردن سيتي. سهرة رأس السنة 2009- 2010.
حُكيَ لي أن شاباً جرّب الحشيش لأول مرة فشعر بغرابة. انقلبت عنده السرعة بطءاً، والبطء سرعة. تحدّث ثم صَمَت. خاطب محدثته. “هل أتكلم كما يجب؟ أشعر أني أسرع بنصف الجملة الأول وأبطئ في النصف الثاني حد القتل”. كان يجد الأمر غريباً، أشبه بشريط صوت متلاعَب بسرعته. “ربما عليَّ أن أتوقف عن الكلام”، قال لها فردّت: إمضِ، إمضِ، “إنت جميل وإنت محشش”.
نهض مقررا أن يتجول في أرجاء المكان. لكأنه مشهد في فيلم، فكّر. البطل يمشي، يلقي نظرة على رواد السهرة، يسمع بعضاً من الصخب العادي الناتج عن المحادثات في حلقات الواقفين الصغيرة، لا يقف معهم، ويتعداهم إلى الرواق، يمشي فيه، ويبقى الرواق مضاءً. لا يحظى بمشهده الموراكامي (نسبة للمشاهد المعهودة في روايات هاروكي موراكامي ). يميل يميناً ويساراً. تتلمس يداه الحائطين. الفودكا وبيرة ستيلا والحشيش فعلوا فيه اللازم. الأغلب أن رجل الماعز لن يظهر. الأغلب أن المصعد لن يظهر له فجأة، ولن يتوقف بين طابقين على طابق جديد.

(غلاف “أرقص أرقص أرقص” لموراكامي)
يدخل الغرفة من باب أول. تستقبله موسيقى أسانسيرات، خفيفة في أذنيه رغم صخبها في الغرفة. تمسك فتاة بيديه، تحاول ترقيصه ولكن أطرافه أثقل (أو أخف) من أن تستجيب. يتركها ويبتسم لكاميرا تقترب. يتطرف في الاقتراب من عدستها. غريب. لطالما كره الكاميرات، فما الذي تغير الآن؟ لعل الحشيش يحيل الإنسان إلى آخر، أو لعله الانسان ذاته لكن الحشيش يؤكد فقط أن الثابت هو محض.. وهم؟
يخرج الشاب من باب، ويكمل السير في الرواق. يدخل باباً آخر فيجد نفسه عاد داخل الغرفة. يدور مرتين ولا يفهم كيف يعود إلى الغرفة في كل مرة فيسأل: هل المكان غرفة واحدة؟
يفلح في الوصول إلى مكان آخر بعد ربع ساعة. يقف قرب منضدة عالية، يتحدث مع الموسيقي. يصر أنه طبيب أسنان، فيصحح له الموسيقي المعلومة: “بلعب مزيكا”. يتغاضى عن جوابه ويحدثه عن أسنانه. يفتح له فمه. يريه شيئاً فيه. داخل اللاوعي وعي كامل، أو لنقل عندٌ كامل. يكتشف الشاب -من دون أن يتخلى عن عنده- أن باب الشقة مفتوح. يهرع فيغلقه ثم يعود لطبيب أسنانه. يتكرر الأمر أكثر من مرة. يقضي السهرة في إغلاق الباب كلما دخل أحدهم. ربما، في اللاوعي، يجب أن تغلق الأبواي لتمنع تسرب التفاصيل إلى الخارج.
حسناً. للشاب مفاجأة بمفعول رجعي: لقد جرب جيم كاري ذلك قبله في فيلم، وانتهى به الامر إلى تسرب كل شيء من رأسه. كل شيء.
***
تاكس كسر الملل
في بيوت مصر، ملصقات وصور.
أحمد صوّر سواقي التاكس. كل واحد منهم وقف قرب سيارته. قال لهم أن يبتسموا. فعل أكثرهم المطلوب وزاد آخرون حركاتهم. بعضهم اتكئ على سيارته (إقرأ لغة الجسد لحركة كهذه)، والبعض الأكثر وقف أمام التاكس كأنه يحميه أو يغطيه من الصورة (هل من فرق؟). ألصق أحمد الصور أفقياً على “الحوائط” في الغرفة. (يستخدم أحمد لفظ “الحوائط” في نصوصه ولا أوافقه على صحته لغوياً. لا أعرف من فينا على حق، ولن أهرع لكتاب اللغة لأثبت النظرية. أستعينبأذني، وأذني قليلاً ما تخطئ. وربما تخطئ وأكون أنا الخاسر في المعركة اللغوية، لكن لا أهتم. أنا فقط لا أرتاح “للحوائط”).

(تاكس مصر – من الانترنت)
على “الحوائط” إذن سواقي تاكس، وروبي (أحب روبي فعلياً لا هزءاً ولي في ذلك نظرية لا يتسع المكان هنا لشرحها ). هناك أيضاً إعلانات حفلات موسيقية لفرق لم أسمع بها، و ملصق ينادي بـ”كسر الملل”. البيتلز حاضرون كما العادة. وهناك ملصق آخر لفيلم مصري تجاري غبي يدعى “آخر الدنيا” بالقرب من ملصق “نادي القتال”. أما رأس غاندي بالأبيض والأسود فيعلو أرجوحة مزركشة في زاوية الغرفة.
“هنا ستنام. على هذه الكنبة”، قال لي أحمد.
***
تشطيب لوكس
على مدخل الكنيسة التي زرتها وجدت إعلاناً مذهلاً. كان اكتشافَ نهاري. “للبيع مدفن بمدينة 15 مايو. كامل التشطيب. المساحة 15 متر”. البعض لم يفهم لِمَ ذهلت آنذاك، وأنا الآن – بعد سنتين- لا أذكر سبب ذهولي. أذكر فقط أني وحين كنت أتمشى خارج مجمع الأديان ركض ولد خارجاً من مدرسته قربي. كان يغني: “الدنيا خربانة، والخلق تعبانة. شوبرا خربانة. إمبابة تعبانة”. أذكر أني عندما سألت بنفس استشراقي سياحي عما يقوله الولد، قيل لي أن هذا غناء شعبي، فلم أعلق وحافظت على ذهولي.
***
طربوش سعد
في إسكندرية، أسأل عن زيزينيا وزنقة الستات. يضحك هيثم (أحدثه على الانترنت عيصم، ويناديني علاء. يمكن النظر للموضوع على أنه مشكلة متبادلة في حرف الهاء لولا اللام التي أصبحت همزة في اسمي الأول والميم التي انقلبت فاءً في اسم عائلتي: شوفان. ). بالنسبة لعيصم، علاء شوفان “بتاع مسلسلات”. “ارحمنا يا عم. تعال نروح عند عبدو النتن”، يقول.
وراء حدائد باب سينما مغلقة ومهجورة وجدت إعلاناً يقول: “فيلمان كبيران في بروجرام واحد” وحكمت حكمي المطلق: “كبيران” في ذاك الزمن تعني إما نادية الجندي أو نبيلة عبيد.
في تجوالي ببعض شوارع الاسكندرية استعدت شوارع الحمرا الفرعية في منتصف تسعينيات القرن الماضي. كل شيء فيها مغلق وقديم. لكني فوراً اكتشفت فرقاً: هناك مبان قديمة ذات معمار جميل بعكس بنايات الحمرا البشعة. فوراً فكرت بوسط بيروت التجاري، لكني تراجعت. بنايات الاسكندرية (والقاهرة) مسكونة لكن غير معتنى بها وإذ أسفت لحظياً لإهمالها، قفز الفارق أمامي: هنا حياة يومية على مدار ساعات النهار لا في ساعات وفترات محدودة كما وسط بيروت. (اليوم أكتشف الوسط أكثر بحكم عملي المستجد في أحد مبانيه، وبعد قراءتي لنص حسن داوود في “فيزيك” بعيداً عن حكمي هذا).
على الكورنيش، يستدير تمثال سعد زغلول باتجاه البحر. قيل لي وقتها: لم يبقَ من سعد زغلول إلا جملته الشهيرة “ما فيش فايدة”. قرأت قبل أن أعبر قرب بيت الأمة أن لم يبق منه إلا ببغاء محنط هنا. ( “حكايات أمينة” لحسام فخر من ميريت ). قيل لي إن سعد بقي فقط في أسماء الميادين التي تحمل اسمه وفي أدوار لممثلين جسدوا شخصيته في مسلسلات رمضانية نفذت برداءة تامة وبتكرار غريب.
 (طربوش لبنان – يؤكـَل)
(طربوش لبنان – يؤكـَل)
لم يبق من سعد إلا الطربوش، فكرت بتطرف. ثم وجدت سيد درويش عنواناُ لمسرح وصوراً في مكتبة الاسكندرية. وجدته حاسر الرأس بلا طربوش.
لو أردت أن أستعيد الاسقاط الرحباني المباشر لقلت أن المعركة في يناير كانت مع الطربوش. لكن الفكاهة المصرية تجعل من توظيف هذا اللفظ ثقيلاً. ط-ر-ب-و-ش. فلأستبدل طرح “الطربوش” إذاً بطرح “بابا” (وأنا لا أفصح عن جديد ). “مغامرة ” يناير كانت مع مفهوم بابا “اللي بيغلط بس بنسامحه عشانا هوة بابا”. حسناً. هذا يبدو تافهاً بالمقاييس اللبنانية. نحن في لبنان حولنا الطربوش إلى رأس شوكولاتي بكريما بيضاء في داخله. نحن في بيروت نأكل الطربوش. هذا يبدو تافهاً للبنانيين كثر، لكن إكبح فرامل استنتاجاتك عزيزي القارئ. البديل الطربوشي ليس بالضرورة أفضل. النقيض ليس بالضرورة أحسن.
***
رسالة: حاجات “باضناني”
لو قدر لنا أن نشبه ما حدث بمصر بمسلسل طويل، لقلت أن “الثورة” قامت في الفترة الإعلانية!! لنقفز سنتين. بدءاً ولأنفي عن نفسي صفة النوستالجيا التي يتهمني بها كثر من أصدقائي في المحروسة، أوجه لهم هذه الرسالة:
أصدقائي في مصر، هذه مصطلحات وحاجات “باضناني”: أخلاق الميدان، مصر الجديدة، حملة النظافة، ثورات الشباب، ثورة الفيسبوك، استقرار، عجلة الانتاج، الجيش ما يعملش كدة، كفاية مظاهرات، مظاهرات فئوية (فئوية؟)، عفاف شعيب، طفولية طرح صفحتيْ “حركة السادس من ابريل”، و”كلنا خالد سعيد” على فايسبوك.
شكراً لتفهمكم. مودتي الخالصة.
علاء شوفان.
***
“الله” والغسالة
وقفت أمام “الله”. هذا ما قاله لي عيصم الذي دخل مع آخرين مركز الأمن المركزي في مدينة نصر. هل قال لي ذلك فعلاً أم أنني ألبسه هذه الجملة التهمة؟ لا أتذكر، وعيصم يستحق تهمة لذا لا لن أشغل نفسي في التذكر الدقيق لما قال. عيصم وجد صور أصدقائه في سهرة خاصة خلال تقليبه لأحد الملفات. قال لي إنّ العناوين على الملفات مفزعة وغبية. عندما شرح لي الأمر فهمت. الناقد الذي كان يراه النظام ناقداً دائماً تحول ورقة في ملف “الشيوعيين”. “نشطاء غزة” صاروا “حماس” (مثلاً). “الناشطون” أصبحوا “مدونين” بالضرورة. صدقاً، ذكرني الأمر بمسلسلات يحيى الفخراني ونور الشريف في رمضان. معركة بين طواحين الهوا الفاسد وحلقة أخيرة في العيد. كيف تحارب الكارتون؟ (أنظر ليبيا). لعلي أكون قد تذكرت أيضاً أفلام سمير الغصيني اللبنانية الثمانينية حيث الأكشن فيها مصنوع برداءة مفرطة، حيث يظهر وسط الفيلم، فجأة، مطرب ثمانيني مروجاً لأغنيته الضاربة ومعطياً الفيلم زخماً لدى طرحه في الصالات. (أنظر مايز البياع).
هذا كان الأمن؟
 (ملصق فيلم “حياتك في 65 (كلمة)” )
(ملصق فيلم “حياتك في 65 (كلمة)” )
عندما أتابع أخبار مصر، يحضرني مشهد من الفيلم الإسباني: “حياتك في65 (كلمة)” (إشتريت الدي في دي مع عيصم في بيروت). في المشهد، يجلس فيه الشاب مع حبيبته على سطح المبنى ينظران إلى الغسالة الاوتوماتيكية تدور بما فيها من ملابس. يبقيان هناك لفترة وتلعب الموسيقى التصويرية وصوت دوران الغسالة الدور الاساسي.
شخصياً، لو كانت الغسالة تتسع لي، لفتحت بابها وانضممت إلى الملابس في دورانها.
***
“الثورة” بنت كلب
في 2010 جاء الناس إلى حفلة رأس السنة باللون الفيروزي. قالو إنه لون السنة. مضت 2010 بطيئة قاتلة. سنة تراكم ستاتيكو تسعيني وألفيني. ما لون ال2011؟ لا أعرف ولن أبحث على غوغل. في 2011، قبيل “الثورة”، أقيمت حفلة كما العادة في المكان نفسه. لم يكن الشاب المحشش هناك. للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات كسر عاداته. هذه “الثورة” استهدفته في العمق. أدارت ظهرها له عامين ولما لم يأت في المرة الثالثة، فعلتها بنت الكلب. الشتيمة جيدة وتريح.
***
“جبروت المصري” (أو ما يتعارف على تسميته بـ”أرجوحة غاندي”)
على الواجهة الزجاحية لأحد محلات الصيانة في وسط البلد بالقاهرة جملة: “المصري طول عمره معرفو بجبروته وقوته. استلم هاردك (القرص الصلب للكمبيوتر) التالف سليم بعد خمس دقائق”.
المصري القوي إذاً يصلح الهارد القديم عوضاً عن شراء القديم. عندما رأى الشاب المحشش الجملة، لم يعرف سبباً لفعل غريب كهذا. كاد أن يلوم حشيش البارحة، ثم سأل: ربما القدرة الشرائية؟ الوفاء للهارد القديم؟ البابا لا يمكن إلا أن يكون قديماً؟ أو ربما لم يحتظ المصري القوي المشهور بجبروته بهارد دسيك موازي، ويود إعادة استخراج المعلومات المحبوسة فيه؟ وهل تتأثر عجلة الانتاج بشراء هارد ديسك جديد؟
صحيح. التنظير من الخارج صعب، وغير أخلاقي. تعاملوا مع كل ما سبق كتنفيسة. تنفيسة من تفاصيل أتابعها عند أصدقائي المضافين على فايسبوك. لا أعرف. الارتياب سيد المرحلة. في الوعي واللاوعي ارتياب. الارتياب يأتي حتى مع العنف الكلامي والتأكيدات في تفاصيل معقدة لا تمشي بمنطق السبب والنتيجة أو من هو المستفيد. يعرف الأكيد منكم أن المسألة أعمق. أجزم أنكم تعرفون ولا أعرف كيف أشرح أكثر صحيح، أنا أجزم بطرح هلامي. في الوقت نفسه، تقول لي تفاصيل يومية إن الباب مفتوح بل مشرع مع النوافذ كلها. تشعرني تفاصيل أن رفاصات لا تزال تعمل. تقذف ناس خرجوا إلى داخل البيت من جديد. وهذه التفاصيل اليومية هي ما تمنعني من التوقف عن استخدام المزدوجين حول كلمة “ثورة”. ربما يجدر إغلاق الباب تماماً كما فعل المحشش؟ لست أكيداً. ربما يجدر الاحتفاظ بالذاكرة وإغلاق الباب أيضاً؟ لكن ألا يستنزف الغرق في الذاكرة الطاقة في غير مكانها؟ صدقاً لا أعرف. إنه الليمبو بين الفعل ورد الفعل. رد الفعل لا معنى له من دون فعل، والرومانسية لا تنفع. ماذا إذاً؟ إصلاح هارد ديسك قديم تالف أو الإتيان بهارد جديد؟
إنها أرجوحة غاندي. ما أجمل عدم المعرفة.